"كافر سبت" لعارف الحسيني..رواية التحولات الاجتماعية وظواهر أخرى
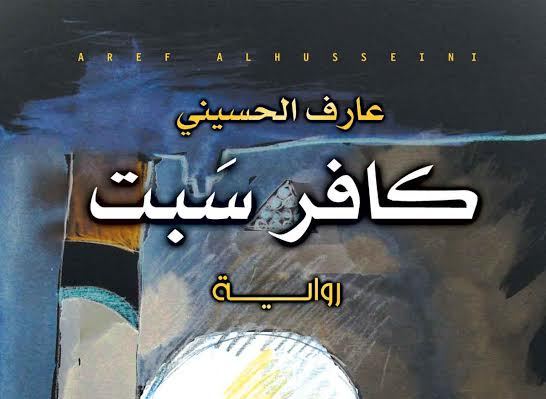
تحسين يقين
تشكل هذه القراءة الجزء الثاني من مقالة نقدية تناولت الرواية، حيث تم في الجزء الأول التركيز على الصراع ومستقبل مدينة القدس، ولا نظن أن التحولات الاجتماعية وغيرها بعيدة عن الحالة السياسية وحالة الصراع بشكل عام.
التحولات النفسية والاجتماعية والفكرية في شخصية "نبيه "، تأتي في سياق التحولات السياسية التي عاشها زمنيا في عقدي الثمانينيات والتسعينيات شابا، وعقد السبعينيات طفلا، وكأربعيني يدخل الكهولة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا زمانيا، أما مكانيا، فالقدس ومحيطها هو مكان الرواية، حيث تعد الرواية مقدسية دارت معظم أحداثها في القدس.
في عقد السبعينيات نرى الطفل يشاهد ويسمع ويتأثر، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات رأيناه يجرّب الحياة: العملية والاجتماعية والسياسية والعاطفية بشكل من الأشكال. في العقد الأخير، حيث يصبح أربعينيا، نراه يتأمل؛ كأن الكاتب الفلسطيني عارف الحسيني يذكّرنا بقصة الحضارة، التي تم تقسيمها تقليديا إلى ثلاث مراحل: المرحلة الحسية، فالمرحلة التجريبية، فالمرحلة التأملية.
فما يمرّ على الجماعة يمرّ على الأفراد، ومنهم "نبيه" ولكون الرواية ممتعة ومشوقة، كان من الممكن عملها ثلاثية، تحاكي مراحل الطفولة والشباب والنضج. لقد كان ذلك ضروريا للتعرف عن قرب على حياة المقدسيين من طبقات مختلفة، من منظور ابن عائلة كبيرة، لكن عمليا قريبة من الطبقة الفقيرة. فالرواية أشبه بتحليل اجتماعي للقدس وسكانها، انطلق من الداخل؛ ففهم الحياة الاجتماعية يلقي الضوء على التطورات السياسية للمدينة ولفلسطين بشكل عام.
في ظل القدس كمكان والفترة الزمنية الممتدة من نكسة 1967 حتى الانتفاضة الثانية عام 2000، وما رافقها من تحولات عاشها الراوي، أمكننا التعرف على عناصر التكوين في شخصيته التي بدأت تظهر للقارئ بعد صفحة 43.
يقدم الراوي شخصية نبيه وأسرته المتواضعة والأعمال التي عمل بها منذ الطفولة، عمله في المجتمع الإسرائيلي في القدس، حيث جرّب عدة أعمال ومهن قادته إلى أماكن مختلفة، وثقافات وتجارب ووعي، ومن خلاله قاد القارئ إلى سار إليه صدفة أو اختيارا.
يصف الكاتب بلغة مؤثرة أسرة نبيه وبيئته والعلاقات الاجتماعية، نراه كهربائيا وعاملا في مخبز، ونراه عاملا في فندق، وموسيقيا (إيقاع) في فرقة غناء تؤدي وصلاتها في الأفراح. نراه موزع جرائد، وهو في ظل ذلك يختلط بمجتمعين مختلفين ومتناقضين الفلسطيني والإسرائيلي، بينهما عداوة بسبب الصراع والنزاع على الأرض.
الحالة النفسية الاجتماعية هي التي تأخذ النصيب الكبير، لكن في العمق تكمن الخلفية التاريخية والسياسية والوطنية، وهي خلفية مؤثرة نفسيا واجتماعيا.
التحول الأول، جرى منذ الاحتلال عام 1967، حيث تم رصد أثر الاحتلال على المجتمع المقدسي، وصور بشكل تلقائي حالة الاندماج غير المتكافئ بين المجتمع العربي والعبري في القدس. وهو اندماج حدث في الجانب الغربي من المدينة، لأنه اندماج مدني بين فلسطينيين وإسرائيليين، أخذ منحى الوجود البرولوتاري للفلسطينيين داخل المجتمع اليهودي في القدس الغربية. في حين كانت العلاقة عدائية في القدس الشرقية، ما لبث أن أخذت الشكل المقاوم، سواء مقاومة الجنود، أو وجود اليهود المتدينين في البلدة القديمة، ثم مقاومة شعبية في الانتفاضة الأولى. إذن نحن بإزاء تفاعلين، وسلوكين للفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص. العمل لدى الإسرائيليين غربا والاشتباك معه شرقا عنى كيف تعرّف المقدسي على الجانب الغربي من المدينة كمجتمع غربي أوروبي، وهو مجتمع جاذب للشباب للعمل والتجارب والانفتاح. وقد سبق هذا التحول تحول آخر، أشار إليه الراوي من الذاكرة، أو من الكتب، وهو تحول تاريخي لم تظهر آثاره الاجتماعية في الرواية، ونقصد به وجود القدس الشرقية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية ضمن ما عرف بالضفة الغربية، فيما تعرض الرواية أيضا للقدس الانتدابية (القدس كاملة) حيث ظهرت آثار اجتماعية، منها التحديث والتمدن، والذي كان الراوي يشير إليه في هوامش الرواية أو في المتن، حيث ضمن الكاتب معلومات تاريخية داخل النص الروائي.
رحلة الاحتلال التي طالت، انعكست اجتماعيا على السلوك، كما أشرنا إلى حالة التناقض في السلوك، وهي الاندماج كبرولوتاريا في القدس الغربية، والرفض في القدس الشرقية، وما واكب ذلك من مشاعر متناقضة، تتفاوت ما بين الاكتشاف والإعجاب والكره والتأمل.
في هذه المرحلة المستمرة حتى الآن، ثمة تصوير لأسلوب تكّيف المقدسي في القدس المحتلة الشرقية، والغربية، والذي يصل إلى إخفاء المشاعر حينا، ومجاملة الإسرائيلي حينا آخر، وهي مجاملة تزداد إلى حدّ الولاء جبنا (ظاهرة العملاء)، وتهبط إلى حدّ مجرد العمل بشكل آلي طلبا للرزق حينا آخر.
ولعل هذا التكيّف يذكرنا بتكيف فلسطينيي عام 1948، كما ورد في رواية "المتشائل" لإميل حبيبي.
وفي هذه الحالة المعقدة، يأتي إلى المشهد اليومي للمدينة، قيام السلطة الفلسطينية، واستثناء القدس وتأجيل قضيتها إلى مفاوضات المرحلة النهائية، والتي سميت بمرحلة الحل الدائم".
في مرحلة السلطة، يصل تأثيرها إلى القدس، حيث تشهد الضفة الغربية التي يصلها المقدسيون ويعملون فيها تحولات اجتماعية وسياسية، وهي تحولات واكبت قيام السلطة، وهي تحولات اقتصادية واجتماعية وفكرية،..والتي تعرض إليها الراوي بشكل نقدي، كما في حادثة حصول مقدسي على جواز سفر فلسطيني، وحالة الاغتراب التي يشعرها المقدسي العادي تجاه السلطويين الجدد، إضافة إلى تحولات سياسية من التناقض والعداء والصراع مع الإسرائيلي، إلى الحوار معه وتقبله، ثم أخيرا التحول الديمقراطي المشوه عبر مشاريع الدمقرطة والجندر، من خلال المنظمات غير الحكومية.
لقد وجّه الكاتب سهام نقده من خلال الرواية، وعلى لسانه كشاهد وراو معا إلى الحياة الاجتماعية في القدس، من خلال تصوير عدة شخصيات: السائق، صاحب الفرقة الغنائية، متعهد العمل، العمة، حارس النادي، سائس الخيول، اليساري القديم، ظاهرة العوانس في العائلات الكبيرة...وهو تصوير للكذب السياسي والاجتماعي، في ظل ذلك من قبل عام 1967 وحتى الآن ظهرت القدس لكن المهمشة، وهو نقد تاريخي سياسي واجتماعي.
نقد تربوي
في سياق النقد الاجتماعي والسياسي، لمسنا النقد التربوي، حيث عبّر الكاتب كخريج لنظام تربوي تقليدي عن سخطه لهذا النظام. وقد جاء ذلك من خلال إيراد مشاهد وذكريات ومواقف مدرسية وجامعية، في حين أعاد لنا شهادته على التأثيرات الإعلامية والتلفزيون على أبناء جيله مثل "السيارة العجيبة". كما انتقد علاقة المعلمين مع الطلاب، وغياب فلسطين عن المناهج، تعليم الأمهات. كأن الراوي يريد أن نصل معه إلى استنتاج بأن النظام التربوي التقليدي يرسخ الواقع السيئ للمجتمع في القدس والضفة بشكل عام.
وهذا الذي جعله يسعى إلى المعرفة البديلة، حيث كان هروبه من المدرسة إلى الأماكن التاريخية والدينية هروبا معرفيا، وهروبا اجتماعيا نافرا من تعامل المعلمين الجامد مع الطلبة.
في ظل النقد التربوي-الاجتماعي، يصبح تصويره لتعامل النساء مع الملابس، حالة أخرى من التناقض، حيث لم تغير الحداثة والعصرنة العقول، بقدر ما غيرت في الشكل فقط، خلال ذلك يتغير الزي القديم إلى الحديث، لكن العقل يظل قديما!
وهنا يبدو أننا نستطيع تأمل إهداء الكاتب والذي له علاقة بالتعليم "إلى كل من علمني شيئا في هذه الرحلة، سواء عن قصد أو بالصدفة، ولم أتمكن من شكره حتى الآن" حيث يوحي الكاتب أنه تعلم من مدرسة الحياة نفسها، وأن الإيجابي الذي تعلمه في المدارس كان صدفة..وبذلك يصبح للمعلم (الحياة والأحداث، الشخصيات العادية) فضل ربما يزيد فضل المعلم التقليدي في المدرسة.
عن المرأة
والنظام التربوي انعكاس للنظامين الاجتماعي والسياسي، كما أن النظام الاجتماعي بما فيه من وضع غائب للمرأة، له علاقة بتفسيرات الوضع السياسي، بمعنى أن تقليدية هذا النظام كانت من تراكمات التراجع العربي سياسيا. لقد حمل النص إشارات تجاه سلوك العمة والانفتاح وظاهرة العوانس وتعليم الأمهات..
من النماذج الفاعلة في النص أم نبيه، كمعيلة، تتقاسم مع الأب رعاية الأسرة، كما تظهر العمة التي يمكن إفراد دراسة خاصة تتحدث عن أثر الحياة الجديدة في ظل الاحتلال عليها، من جهة، ونظرتها التقليدية تجاه المجتمع من جهة أخرى. وظهر ذلك في تصويره الشكلاني لتعامل النساء مع الملابس والذي لم يصل فيه التأثير إلى المضمون.
فإذا كان يمكن حصر ورصد المرأة المقدسية، فإن هناك ما غاب من حضور ودور للمرأة المقدسية، والذي يمكن استنتاجه من السياق، حيث يمكن بسهولة التعرف على الجانب الخفي المتعلق بدور المرأة في الأسرة، في ظل النزاع وظروف الفقر.
كنا نودّ لم تم تعميقها أكثر، لتلقي الضوء على الحالة السياسية المتراجعة وصولا إلى الهزيمة.
وأخيرا لعلي أركز على الجانب الاستفزازي للتغيير الاجتماعي والتربوي والسياسي، وهو إن لم يقدّم بدائل، إلا أنه أوحى بها كما ذكرنا عن دور النساء، وهي البدائل الإبداعية في التربية، والنظر لمستقبل الصراع والمستقبل الاجتماعي والسياسي..إنه يدفعنا للتفكير والبحث المسؤول.
الشكل الفني
أهم ما فيه هو المضمون ومقول القول، الأحداث، التفاصيل الصغيرة، متعة القراءة والتشوق، اللغة الساردة العادية البعيدة عن الجماليات اللغوية، لذلك نستطيع القول أن رواية "كافر سبت" هي رواية المضمون، جوهر الأحداث وجوهر البشر وجوهر الراوي.
وقد جاء النص ليقدم ذلك.
ولأجل أهمية النص لم يحفل الكاتب بتقنيات وتعقيدات في السرد، بقدر ما لجأ إلى التلقائية والسرد العادي الانفعالي.
لقد استخدم ضمير المتكلم، فمنح النص مصداقية، فكانت الرواية رواية سيرة.
حتى أن استدعاء الماضي جاء من خلال إلقاء الضوء على الشخصيات، من ذلك حديثه (التقديم والتأخير) أو الفلاش باك في لغة السينما، كما في صلاح الدين الجد، وعودته من أمريكا.
المعلومات هي الأخرى ارتبطت بالتنوير عن الأماكن، التي ارتبط فيها، مثل المدرسة، الست طنشق، الجامعة العبرية، المطار، المدرسة اليهودية في مكان معركة الخنادق، باب الاسباط، المقبرة،...
ويمكن التحدث عن اللغة، فكون المضمون هو الأهم، فهذا يعني أنه استدعى هذا الشكل العادي من اللغة بعيدا عن التشتت. وهذا يعني أنه حينما يكون الكاتب ذا مضمون هام تصبح اللغة طيعة، وتلك هي بلاغة اللغة، حين تقدم مضمونا مهما بلغة عادية.
كما أن السرد حينما يكون سردا لمضمون أهم، فإنه يرتقي. فليس السرد هو المهم في حد ذاته، بل ما يوضع في وعائه.
كما أن بعض مقاطع السرد يمكن أن تكون قصصا قصيرة..
لقد كان السرد انفعاليا، وعانى من الخطابية أحيانا، لكن ذلك لم يخل بالعمل الأدبي، حيث أفرغ الكاتب شحنات قلقه وقلق القراء، لكن ربما يحسن ألا نظهر الانفعال سرديا.
لقد وصل الكاتب إلى مرحلة التأمل بشكل خاص في آخر فصلين، حيث قلت الأحداث وزادت لغة التأمل والخطاب، وكان يمكن أن يؤثر ذلك على بنية الرواية وشكلها، فقد كان يمكن أن يحولها إلى شكل مقالي.
من تأملاته المهمة، تأملات ما بعد الموت وقدسية منطقة المقابر للأديان الثلاثة.
*صدرت الرواية عن دار الشروق في عمان ورام الله




