فيلم ‘يرموك’ لمحمد بكري من الترميز الفني إلى التشويه العقائدي
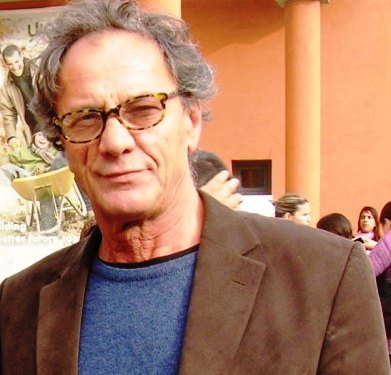
بقلم: صادق أبو حامد
عنيفة كانت ردود الفعل على فيلم ‘يرموك’ لمحمد بكري، النقد اللاذع والتجريم والتخوين من جهة، ودفاع شرس ينزع صفة النقد أو الثقافة أو حتى الإنسانية ممن يتطاول على الفنان العظيم من جهة أخرى. هي صورة المصارعة التي اعتدناها في ثقافتنا منذ عهد ليس بقريب، ليس فقط للسبب الذي يُذكر عادة من أننا شعوب لم تمارس الديمقراطية ولم تعتدها، وإنما لأن الشرخ الواقع في المواقف منذ انطلاق ثورات الربيع العربي بلغ حدوده القصوى، وأكثر تلك الثورات إثارة للشقاق بلا شك الثورة السورية.
أن تدخل الحريق بمعطف من ورق
لكن هل كانت هذه الحقيقة غائبة عن بكري الأب والابن حين قررا الخوض في موضوع مخيم اليرموك؟ هل كان غائباً عنهما أن الشحنات الجبارة التي يحملها الملف السوري تتطلب قدراً كبيراً من المعرفة والذكاء والدقة قبل الخوض فيه؟ ثم هل كان غائباً عنهما أن أكثر ما يجعل الملف السوري حقل ألغام هو، إضافة إلى الإجرام الاستثنائي الذي وقع على الشعب في سوريا، قضية فلسطين وتبرير البعض لمسلسل الإجرام الأسدي الإيراني بحجة ‘المقاومة’؟ أي أن بكري حين قرر تناول مخيم اليرموك سينمائياً، إنما كان يدخل في عين الإعصار، لكنه قرر الدخول كما يبدو بالقليل القليل من الحكمة.
صحيح أن اتساع ساحات النقاش الذي أمنته الوسائط الاجتماعية خلق ما يشبه المهرجانات الجماهيرية من القدح والمدح، وما قد يجره ذلك من تسفيه وتشويه للقضايا الخاصة والعامة، فكثيراً ما تسقط هذه الضوضاء الهائلة في التعميم، وتهمل التفاصيل، رافعة أحدهم إلى السماء، وهابطة بآخر إلى قاع الأرض، ومحمد بكري في هذا التوصيف أصابته الصاعقة فأحرقت صورته دفعة واحدة. لكن أليست هذه مقدمات الديمقراطية، وأليست المشاركة الواسعة والحماس المفرط هو من سمات منعطفات التاريخ التي نعيشها ملياً في هذه المرحلة، ثم أليس من يصعد على مسرح الجمهور، يدخل بإرادته حيز التقييم والحكم، وبالتالي عليه أولاً أن يتحمل مسؤولية عرضه!
بالمنظار النقدي المتجرد يبدو البناء الفني للفيلم القصير محكم وسلسل، ولا يخيب تمثيل محمد بكري ظن محبيه في حميمية أدائه. إلا أن القدرة الفنية للعمل، اتفقنا في تقييمها أم اختلفنا، لم تكن بأي حال سبب الزوبعة التي أثارها الفيلم. فالعمل الفني الذي يطال قضية شائكة سياسية كانت أم اجتماعية، يقدم نفسه كأطروحة، ولدى البعض كرسالة، يرغب في إثارة إسئلة في السياق الواقعي، السياق الذي وضعه محمد بكري بإرادته حين افتتح فيلمه بإشارة للحظة السياسية التي تقول ‘جراء الأحداث الدامية التي اندلعت فيسورية منذ 2011، تشرد مئات الآلاف وعضهم الفقر والجوع′، وحين أقفل فيلمه بإهداء سياسي ‘إلى الأمة العربية’. لا يخطئ الناس إذن حين يطلقون انطباعاتهم وآراءهم حول الفيلم من زاوية الواقع والسياسة، وليس لنخبويي الثقافة بالتالي أن يتهموا الناس بالجهل لمحاكمتهم للفيلم أساساً من خلال فكرته، وحكايته، وإذا كان لمفردة الجهل أن تحضر هنا، فالأحرى أن تكون باتجاه آخر تماماً، اتجاه مصدر الإبداع وليس ساحة التلقي.
مستعيناً بالجهل.. يريد إظهار الحقيقة
مع ذلك تبقى أولى المرافعات المدافعة عن الفيلم التي تستحق الذكر هي أن الفيلم عمل فني رمزي، ومن السطحية محاكمته بأدوات غير فنية وأن يُطلب منه، أو يُعتبر، صورة مطابقة للواقع. رأي يبدو جديراً في الحالة المطلقة، لكنه لا ينقذ فيلم محمد بكري بأي حال. ففي عمق الممارسة، ينجح الترميز حين يكون تتويجاً للمعرفة، بوصفه خلاصة لرؤية متعمقة تجاه قضية ما، ولسلسة من التراكم المعرفي. غير أن فيلم بكري يظهر منذ لحظاته الأولى مفتقراً أساساً للعمق والمعرفة معاً. بل إن أول ما يثير الانتباه في الفيلم القصير هو الجهل العارم بمخيم اليرموك، ابتداء من العمران والبيئة السكنية مروراً بالحالة الاقتصادية وانتهاء بالظروف الاجتماعية والنفسية ناهيك عن الظروف السياسية وأولها ظروف الحصار التي كانت منطلق صناعة هذا الفيلم. جهل يفسر إلى حد بعيد الصورة المفارقة للواقع التي يقدمها الفيلم.
لا شك أن من يعرف مخيم اليرموك سيكون الأكثر رفضاً لهذا الفيلم، ولا بد أن ابن مخيم اليرموك، وكاتب هذه الكلمات من أبنائه، سيصعب عليه التحلي بالموضوعية تجاه حكاية تختزل معاناة وصمود أبناء المخيم لمدة ثلاث سنوات من صلف النظام وبطشه، من قصفه للناس واعتقاله للشباب وقتلهم تحت التعذيب، اختصار كل ذلك في حكاية أب تجبره ظروف حصار المخيم على بيع ابنته لرجل خليجي ليطعم بقية أبنائه. هذه الجملة القصيرة تحكي قصة الفيلم كاملة. لكنها لا تحكي شيئاً عن قصة المخيم، وهنا موضع المشكلة.
ربما تكون رمزية الفيلم قادرة على أن تبرر لبكري فنياً ما يبدو غير منطقي في فيلمه، من وصول السيارة المغتصبة رغم وجود الحصار، إلى شراء بعض الموز والفاكهة بينما الجوع الكافر لا يسأل عن طعم الوجبة، ويبرر إقحام طلب فتح فم الفتاة لرؤية أسنانها إمعاناً في رمزية الإذلال، وربما يبرر له أيضاً الحديث عن خمسئة وألف من عملة تكاد تكون آلافها بلا قيمة شرائية. لكن ما الذي سينقذ صاحب الفيلم من رفض المتلقي لدلالة الرمزية لديه إذ تجعل من الشعب الصابر المناضل كائناً سلبياً منهزماً ذليلاً، ومن سينقذه من تكذيبنا للواقع الذي يخترعه الفيلم، واقع يفتح عينه على الضحية، ويغلقها بلؤم كي لا يكشف المجرم.
هل كان محمد بكري يريد العنب وأن يقاتل الناطور في آن معاً حين أعطى في صورة المأساة التي يقدمها مسميات صريحة لكل شيء سوى لمرتكب المأساة؟ أم أن رمزيته شاء لها مزاج الشاعر أن تكون فضائحية في كل شيء، ولم تأتها الحشمة إلا عند ذكر سفاح الحكاية!
في غمرة النمطية ضاعت القضية
قد يكون من المفهوم بناء الحكاية على قضية بيع أب لابنته بسبب الفقر، باعتبارها رمزية تقصد تصوير حجم المعاناة، وكان يمكن قبول هذه الحكاية بصورتها الفنية دون كثير انتقاد، وحتى قضية أن يكون الأب فلسطينياً ما كانت لتستحق الكثير من الرفض إلا عند من يحبذون تقديس الفلسطيني، غير أن الصورة ذاتها حين توضع في سياق محاكاة لواقع مخيم اليرموك المعقد، وموقف الفلسطيني الأكثر تعقيداً داخله، وفق وجهة نظر معاكسة للواقع، تجعل منها نشرة تلفيقية صادرة عن قسم التوجيه السياسي في حزب عقائدي.
نشرة تبنى خطابها على ممارسة فاحشة للتسطيح تجاه الشخصية الفلسطينية وتجاه الشخصية الخليجية، تسطيح يأتي ليصب بدقة في مصلحة رأي سياسي محدد، وموقف صريح من الثورة السورية. فالجمع بين الفلسطيني (أو السوري) اللاجئ البائس مسلوب الإرادة قليل الحيلة، والخليجي الشره المستغل لمآسي الآخرين المتآمر على أحلامهم، تجد مكانها فقط في خطاب النظام السوري، في خطاب ‘المقاومة الإيرانية’ التي لا تقبل الفلسطيني إلا كممر لامتلاك ساحة الشعارات، ولا يعنيها من الخليجي سوى صورته النمطية التي باتت الزركشة الأهم للمؤامرة الكونية!
قد يقول مدافع أن بكري لم يكن يهرب من تسمية الأشياء بمسمياتها حين سمّى ما يقع في سوريا بـ ‘الأحداث الدامية’، إنما أراد فقط أن يوسع دائرة المتلقين لفيلمه من خلال عدم تبنيه لأي تعبير يُظهر موقفه من أحد طرفي الصراع في سوريا، وهو خيار مشروع فنياً، إلا أنه يحمل في بطنه موقفاً محدداً من الثورة السورية، الموقف الذي سرعان ما يظهر بجعل مأساة اليرموك أشبه بكارثة طبيعية لا فاعل لها، ولا مسؤول عنها. في الوقت الذي لا يتردد في إظهار هوية ضحيتها (الفلسطيني)، وهوية مستثمرها (الخليجي). العائلة الفلسطينية في الفيلم سلبية معدمة بانتظار قرار الأب، والأب سلبي معدم تحت حكم القدر، أما كيف ولماذا هم على هذه الحال، فذلك خارج إطار الفيلم، فالمخرج لا يريد الدخول في تفاصيل الصراع بين الشعب والطاغية، ولا يجد سبباً للإشارة إلى المسؤول عن الحصار، وإذا كان لأحد أن يبرر ذلك بحرية الفنان في خياراته الفنية، فلنا أن نرد بأن هذه لا تلغي حرية المتلقي إذن في تقييم خيارات الفنان، كما أنها لا تجيب عن السؤال المضطرب في حلق الجمهور: ولماذا يُتعب الفنان نفسه إذن بالحديث عن المخيم طالما أنه لا يرغب في التلوث بتعقيدات الحالة السورية؟ وكيف يمكن أن يُبرر فنياً، أو معرفياً، أو سياسياً، أن تكون هناك إرادة بتناول قضية بالتوازي مع قرار بعدم التعمق في معرفتها ولا الدخول في تفاصيلها!
ولتتضح الإشكالية دعونا نقترح على الفيلم الافتراض التالي: ما الذي كان سيتغير في حكاية بكري لوأن المخيم لم يصمد، لو أن المخيم خسر هويته ونبضه وإرادته؟ بل أي فيلم كان سيخرج بكري لو أن حكايته ‘الرمزية’ كانت هي الحقيقة، وأن أهل اليرموك باعوا أنفهسم وبناتهم ليأكلوا؟ وعلى المنوال نفسه نسأل المخرج: أي فيلم كنت ستنجز لو أن مأساة اليرموك سبّبها فعلاً زلزال أو تسونامي أو أي عامل طبيعي آخر؟ هل كان هناك ما سيستدعي إعادة النظر في الفيلم! لا أعتقد أن شيئاً كان سيتغير في الحكاية لأن سطحية الرمز تجعله ممكناً في أي سياق لكنها تفرغه من القدرة على إظهار الخصوصية، ومن ثم لم يكن هناك ما يخص اليرموك حقيقة في هذا الفيلم، كي يتغير بتغير حكايته. فالدقائق الثماني التي حملت اسم مخيم اليرموك لا تشبه المخيم في معماره ومجتمعه وحكايته وصعوباته وتحدياته، لا شيء سوى أحرف العنوان المقحم بإرادة مبدع العمل. وواقع الأمر أنه لو نزعنا الإشارة إلى سوريا واليرموك في شارة المقدمة، لكان الفيلم صالحاً كقصة رمزية (قليلة الإبداع) تحاكي الذل الذي يفرضه الفقر في أي مكان من العالم.
يداك أوكتا.. وفوك نفخ
بعد انتشار الفيلم، ظهرت صفحة عامرة بالتوقيعات على موقع الفيسبوك ضد فيلم ‘يرموك’، صفحة أكثر ما يهمها ليس اعتذار محمد بكري، بقدر حجب الثقة عن تمثيل فيلمه لأهل المخيم، نزع الحق الذي يفترضه الفنان لنفسه في رواية حكاية المخيم، ورفض العمل الذي يجدر وصفه بالبروباغندا الموالية لحلف إيران، والذي يجرد فلسطينيي اليرموك من الكرامة التي مازالوا يدفعون من أجلها أغلى ما لديهم. أما إذا كانت الأصوات التي انطلقت ضد فيلمه دفاعاً عن صمود المخيم قد خدشت البراءة الفنية لبكري، فحبذا لو يقارن تلك الخدوش بالجرح الغائر الذي خلفه فيلمه في ظهر المخيم، علّه يسأل نفسه بعدها: بأي ذنب طعنته!
ليس للنقد، فنياً كان أم معرفياً، أن يكترث بالنوايا في تقييمه لعمل ما. غير أن قلوب الناس كبيرة كما يقال، ولمحمد بكري فرصة أن يخاطب هذه القلوب، فإذا كانت النوايا صادقة، والقراءة خاطئة، فليس هناك ما هو أبسط من أن يعتذر عن إهانة أهل المخيم دون قصد، أما إذا كان الأمر يتعلق بموقف المخرج الحقيقي مما يجري في سوريا، واختياراً للوقوف إلى جانب الطاغية الذي يحاصر المخيم، فلن يكون صعباً على الناس إسقاطه في القائمة السوداء، القائمة التي كان للفنانين النصيب الأكبر فيها، فماذا وأن يزيد اسم محمد بكري في أسفل الصفحة.




