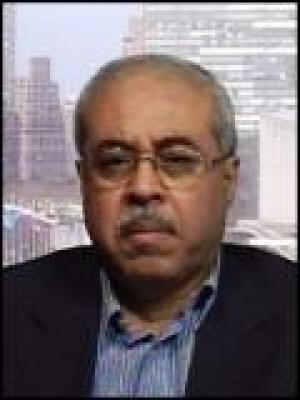هل هذه انتفاضة أبو مازن؟
بينما كان العالم بانتظار اتفاق إطار يمهّد لتسوية فلسطينية - إسرائيلية، إذا به يحصل على اتفاق إطار بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيستين، «فتح» و «حماس»، توخّتا فيه إنهاء انقسام الكيان الفلسطيني بين الضفة وغزة، وإنجاز مصالحة وطنية كاد الفلسطينيون ييأسون من انتظارها. لا شكّ في أنه يمكن قول أشياء كثيرة عن هذا الاتفاق - المفاجأة، أهمها أنه جاء في ذروة أزمة سياسية ووجودية للحركتين المذكورتين، إضافة إلى أزمة الشرعية. القصد أن اتفاق الضرورة والمصلحة هذا، وبغضّ النظر عن الأمنيات أو الرغبات، لا يشجّع على التفاؤل، بالنظر إلى تجربة الانقسام المريرة، وبالقياس الى التنصّل من الاتفاقات المعقودة سابقاً في مكة وصنعاء والقاهرة والدوحة، لا سيما أن نصّ الاتفاق الجديد لم يتطرّق إلى نقاط الخلاف الأساسية، بشأن المكانة السلطوية لكل من «فتح» في الضفة و «حماس» في غزة. ومعلوم أن التوافق الحاصل اقتصر على تأليف حكومة «تكنوقراط»، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية (في غضون ستة أشهر)، وتفعيل الإطار القيادي الموقّت.
أيضاً، ثمة ما لا يشجّع على التفاؤل بشأن الاتفاق الحاصل بالنظر إلى أن الأزمة الفلسطينية هي في الحقيقة، أزمة مشروع تحرر وطني، وأزمة خيارات وبني وعلاقات وأشكال عمل، أي أنها أكبر وأعمق وأعقد وأسبق من انقسام السلطة، ومن الخلاف بين «فتح» و «حماس»، بخاصة أن هذه الأزمة تشمل هاتين الحركتين، في بنيتهما وفي خياراتهما السياسية وتحولهما من حركة تحرر إلى سلطة. والمعنى أن إنكار هذه الحقيقة لن يغيّر من الواقع الفلسطيني كثيراً، مع مصالحة أو من دونها. لذا، فإن الاتفاق المذكور سيفضي، في أحسن الأحوال، إلى نوع من شراكة اضطرارية بين «فتح» و «حماس» في إدارة السلطة، وربما في إدارة العمل الفلسطيني عموماً، إلى هذه الدرجة أو تلك.
والحال، فإن هذا الكلام لا يقلّل من أهمية ما حصل، هذا إذا تم التمسّك به، وخصوصاً إذا تم الاشتغال عليه بتحويله إلى واقع، وبتطويره، إذ إن أي اتفاق أحسن بكثير من عدم الاتفاق، بين هذين الفصيلين، أولاً، لأن ذلك يمكن أن يساهم في إنهاء حصار قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني فيه كانوا عانوا الأمرّين خلال الأعوام السبعة الماضية. وثانياً، لأن ذلك قد يوقف حال العبث والاستنزاف في الجسم الفلسطيني، والذي أدى إلى تبديد طاقة الفلسطينيين، بدل تركيزها في مواجهة إسرائيل وسياساتها. وثالثاً، لأن هذا الأمر يمكن أن يساهم في تغطية حركة «حماس»، بتكييفها في الإطار الوطني العام، بعد التحولات الحاصلة عربياً، وبعد كل هذا الشقاق بين الفلسطينيين، ما يخدم هذه الحركة بخاصّة والحركة الوطنية الفلسطينية بعامة.
أما إسرائيل فرأت في هذا الاتفاق تمرداً على سياساتها، ونوعاً من الخروج عن الصورة النمطية التي اعتادت عليها عن القيادة الفلسطينية، باعتبارها مجرّد قيادة خانعة، ولا تملك خيارات أخرى، وهي الصورة التي شجّعت إسرائيل على انتهاج اللامبالاة إزاء الفلسطينيين، والإمعان في قضم حقوقهم وامتهان كرامتهم، لا سيما مع اتفاقات التنسيق الأمني والاقتصادي، خلال عشرين عاماً.
وفي الواقع، فإن إسرائيل لم تترك منفذاً للقيادة الفلسطينية، باستهتارها بكل الاتفاقات التي وقّعتها معها منذ عقدين.
ويبدو من كل ذلك أن القيادة الفلسطينية باتت تدرك أنها وصلت إلى عتبة ما عاد يمكن معها التنازل أكثر، والأهم أنها باتت تعي أن تصوّر إسرائيل للتسوية لا يتلاقى مع الحد الأدنى المقبول عندها، ولا يتضمن دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة، وأن كل ما تسعى إليه إسرائيل في الضفة هو إيجاد نظام سياسي مختلط، ثلاثي الأبعاد، يتشكّل من نظام استعماري إزاء الأرض الفلسطينية، ونظام فصل عنصري يميّز بين المستوطنين والفلسطينيين، ونظام حكم ذاتي للفلسطينيين يغطّي على النظامين السابقين، ويجنّب إسرائيل الأعباء السياسية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية المترتبة على كونها دولة احتلال. أي المطلوب تسهيل سعي إسرائيل إلى احتلال مريح ومربح وبرضى السكان الأصليين!
وفي وضع يسيطر فيه الرئيس على السياسة الفلسطينية، ويتحكم في خياراتها، من الصعب التكهّن بالطريقة التي ستسير فيها الأمور، نظراً إلى التجارب السابقة وطبيعة الطبقة السياسية السائدة التي تدين بمكانتها لخيار المفاوضة والتسوية. مع ذلك، ثمة ما يشي بإمكان ذهاب أبو مازن إلى خيار أبو عمار، بعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000)، وإن على نحو آخر، بحكم الاختلاف في طبيعة الرجلين واختلاف تجربتهما الشخصية، إدراكاً منه لأنه وصل إلى نهاية طريقه السياسي، بعد كل هذا العمر، لا سيما أنه أفصح عن ذلك مراراً، إن في حديثه عن الاعتكاف أو في حديثه عن «حل السلطة». أيضاً يمكن اعتبار كل ما جرى، أي وقف المفاوضات والمصالحة، جزءاً من عملية الصراع التفاوضي ضد إسرائيل. علماً أن الرئيس ذاته كان أعرب عن محدودية هذه المعركة السياسية، في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله (26/4)، بتجديد تمسكه بخيار المفاوضات وبشروط «الرباعية» الدولية (الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات السابقة)، ناهيك بكلامه المتكرر عن التزامه عدم نزع شرعية إسرائيل، على رغم إدراكه أن هذه تفعل عكس ذلك تماماً.
وحقاً، ثمة ما يغري في المقارنة بين تجربتي الرئيسين ابو عمار وأبو مازن، إذ إن الأول انتظر عاماً واحداً بعد انتهاء فترة الحكم الانتقالي، ليعود من مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000) ويشعل الانتفاضة الثانية. أما أبو مازن ففهم الدرس وعرف حدود القوة الفلسطينية، وأبدى انضباطاً لعملية التسوية أكثر مما يجب. وبالنتيجة فقد اضطر أبو مازن للانتظار قرابة عشرة أعوام (2005-2014) كي يذهب نحو انتفاضته الخاصة، من دون مقاومة مسلحة وحتى من دون مقاومة شعبية، وهو ما تمثّل في سعيه المتدرّج لأخذ الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة (2012)، والانضمام إلى المعاهدات الدولية، وأخيراً في محاولته استعادة وحدة الكيان والنظام الفلسطينيين، في عقده اتفاق مصالحة مع حركة «حماس».
وعلى أي حال، ومع كل التخوّفات، فإن إضفاء صدقية على التوجهات الفلسطينية الجديدة يتطلب ترجمتها وترسيخها في الواقع، كما يتطلب تأمين متطلباتها، علماً أن الأحوال الدولية وتبرّم الإدارة الأميركية والدول الأوروبية من إسرائيل، واتساع مسارات المقاطعة لها ونزع الشرعية عنها، تساعد على ذلك.