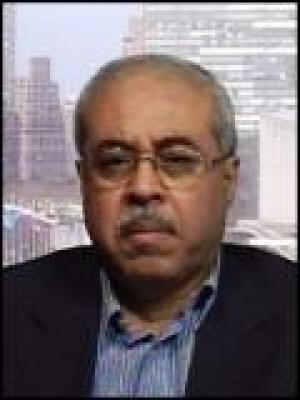نحو مراجعة فلسطينية لمعنى التحرير
في عملية واسعة للجيش الإسرائيلي، ضمت 40 جندياً، مع آليات مصفحة وجرافة، تمت تصفية الشاب معتز وشحة، بين ذويه (27/2)، كما جرى هدم أجزاء من منزل عائلته في بير زيت، بجوار رام الله، حيث مقرّ السلطة الفلسطينية.
ليست هذه العملية الأولى من نوعها، ففي حين يجرى التركيز على النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين، يجرى طمس السياسات التي ينتهجها جيش إسرائيل في الضفة الغربية، بصفته قوة احتلال. فقد نتج من عمليات هذا الجيش، عام 2013 مثلاً، مصرع 49 واعتقال 3890 من الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة، التي يفترض أنها خاضعة لولاية السلطة. ويأتي في هذا السياق هدم البيوت ومصادرة الأراضي ونشر عشرات الحواجز، التي تحد من تواصل الفلسطينيين، ناهيك عن السيطرة على اقتصادهم ومواردهم ومعابرهم، إلى درجة أن «وكالة المساعدات الدولية» أكدت في تقرير لها أن «حياة ملايين الفلسطينيين أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاماً، أي قبل قيام السلطة. («الحياة»، 15/9/2013). وكانت المحللة الإسرائيلية عميره هس تحدثت عما سمّته «التمييز في الماء» باعتباره «وسيلة سلطوية أخرى لاستنزاف الفلسطينيين اجتماعياً وسياسياً». («هآرتس»)، إذ تستولي إسرائيل على مصادر المياه في أراضي الفلسطينيين وتبيعها لهم بأسعار باهظة!
والحال، فإن إسرائيل، من خلال سياساتها هذه، تبعث برسائل تفيد بأنها لا تبالي باتفاقات التسوية، وضمنها اتفاقات التنسيق الأمنية، على رغم إجحافها بحقوق الفلسطينيين، وأنها تعتبر ذاتها صاحبة السيادة على كل الأراضي من النهر إلى البحر، وضمنها القدس والضفة، وأن السلطة بالنسبة اليها هي مجرد ديكور، أو ملحق، أو لزوم علاقات عامة، لا سيادة فعلية لها على أي شبر. وينجم عن ذلك أن أجهزة أمن السلطة، التي تستحوذ على أكثر من ثلث الموازنة، مع عشرات ألوف العاملين، ليس الغرض منها حماية مواطنيها الفلسطينيين، أو الدفاع عنهم، وإنما ضبط احوالهم، والحفاظ على الهيكل الواهي للسلطة.
هذه هي الحقيقة المرّة التي ينبغي على القيادة الفلسطينية أن تصارح شعبها بها، إذ ليس من المعقول أن تواصل التمسك بسياسة «النعامة»، للحفاظ على كونها سلطة ليست لها من السيادة سوى السيطرة على شعبها، مع علم ونشيد وسفارات ومراسم.
معلوم أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالزعيم الراحل ياسر عرفات، وبشهادة العالم، قدمت التنازل التاريخي الأكبر لإسرائيل باعترافها بها في حدود 1948، وبالتحول نحو المفاوضات لتحصيل الحقوق، لكن كل ذلك لم يلقَ استجابة مناسبة، إذ إن إسرائيل كانت تأخذ كل تنازل وتضعه في جيبها، وتتقدم بطلب آخر، وفق اعتراف الرئيس ابو مازن، وهذا ما بات يصدق عليه الكثير من المسؤولين الدوليين وحتى الإسرائيليين. وعلى هذا المنوال برّرت إسرائيل تملصها من خطة «خريطة الطريق» (2002) بـ «الأمن أولاً»، ثم بعد أن وفّى الفلسطينيون بقسطهم، طرحت في عهد اولمرت قصة «التبادلية» كتغطية لضم مستوطنات الضفة، ثم بعد أن أمّنت هذا وذاك طرح نتانياهو بدعة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإبقاء على الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.
واضح من كل ذلك أن إسرائيل لا تريد من الفلسطينيين أن يعترفوا بها فقط، وأن يتنازلوا لها، أيضاً، عن جزء من أراضيهم في الضفة وعن سيادتهم عليها، وإنما هي تريد منهم، فوق كل ذلك، أن يعترفوا بهزيمتهم، ولا أقل من هزيمة كاملة، بإزاحة السردية الفلسطينية عن قيام إسرائيل، وعن النكبة، والإقرار بالسردية الإسرائيلية، في مقابل إقامة كيان مشوّه، وتابع، من حيث المعنى والمبنى.
وفي الواقع، فإن إسرائيل نجحت باختزال قضية فلسطين إلى مجرد قضية إقامة كيان سياسي، ونجحت في هزيمة الحركة الوطنية الفلسطينية، بتحويلها إلى نوع من سلطة لجزء من شعب فلسطين على جزء من أرض فلسطين، كما نجحت في اختراق وعي الطبقة السياسية الفلسطينية السائدة التي بات همها ليس اثبات عدالة قضيتها، والكفاح من أجل الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وضمنها حق العودة، وإنما إثبات اهليتها لثقة إسرائيل، من النواحي السياسية والأمنية، وضمن ذلك «تفهّم» ادعاءاتها بشأن رؤيتها لأمنها، وشرعيتها، ومخاوفها الديموغرافية.
المؤسف أن القيادة الفلسطينية، في غضون انشغالها بوهم التسوية، وإدراكها للفجوة في موازين القوى وللظروف الدولية والعربية، المعقدة وغير المواتية، لم تكتف بإزاحة «حق العودة» إلى الخلف فقط، وإنما أخرجت ملايين اللاجئين من معادلات الصراع ضد إسرائيل، وهمّشت الكيان السياسي الجامع المتمثل بمنظمة التحرير، لمصلحة السلطة. وهي فوق ذلك لم تكتف بقبول دولة في حدود 22 في المئة من أرض فلسطين بل وصل بها الأمر حد القبول بمبدأ مبادلة أراض، كأنها ترضخ لشرعنة الاستيطان. أيضاً، هي لم تكتف بإنهاء المقاومة المسلحة بل إنها انخرطت في علاقات تنسيق امني مع إسرائيل، وحتى وصل بها الأمر حد وقف المقاومة الشعبية، ووقف ما يسمى «التحريض»، كأن من متطلبات التسوية أن «نعشق» إسرائيل التي تتعرض لنقد من اليهود والإسرائيليين ذاتهم!
وعلى رغم أن هذا كله غير مجد، فإنه غير مقبول وغير منطقي، إذ لا يوجد شعب يتنازل عن قضيته إرضاء للطرف المستعمر بدعوى التسوية، لأن التسويات، حتى النسبية والمرحلية والجزئية والموقتة، لا بد من أن تنطلق من معالجة جذور القضية ذاتها، أي لا بد من أن تتأسّس على الحقيقة والعدالة، ولو النسبيين، لأن في غياب ذلك لا تكون تسوية، بقدر ما تكون مجرد عملية هضم او إلحاق او هيمنة، تحت مسمّيات أخرى.
على ذلك، وإذا كان يمكن تفهّم العجز عن مواجهة إسرائيل، والظروف غير المواتية، وعدم القدرة على تحصيل الحقوق، فإن ذلك لا يضفي أية شرعية على التنازل عن القضية، أو عن الرواية الأصلية، ناهيك بأن التنازل لا يغير من واقع الأمر شيئاً، إذ الاحتلال سيبقى احتلالاً، والهيمنة على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم وهويتهم في هذه الظروف ستبقى، مع قيام كيان سياسي لجزء منهم، أو من دون ذلك. بل إن قيام كيان كهذا قد ينجم عنه تبييض صفحة إسرائيل، والاعتراف بروايتها، بمفعول رجعي، ما يضر بصدقية كفاح الفلسطينيين وعدالة قضيتهم، ناهيك عن أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض وحدة الفلسطينيين كشعب، وتصدّع هويتهم الوطنية وكيانيتهم السياسية، كنتيجة لاختزالهم بفلسطينيي الضفة والقطاع واختزال فلسطين بهاتين المنطقتين.
الآن، إذا كان المشروع الفلسطيني الذي اختزل سابقاً في هدف «التحرير»، على نحو ما جاء في التصورات الأولية للمشروع الوطني في الستينات والسبعينات، والذي يأتي كنتاج لحرب شعبية بالاستناد الى دعم جيوش أنظمة عربية، قد تجاوزه الزمن، لا سيما أن التجربة بينت قصور القدرة على انجازه، لأسباب عدة، فإن البديل من ذلك ليس التخلي عن الرواية والحقوق والطموحات الفلسطينية، لا بحجة موازين القوى، ولا بأي حجّة، لأن ذلك لن يحل شيئاً، ولأن القضية الوطنية، والأسئلة المنبثقة عنها، ستبقى هي ذاتها.
القصد أن البديل يكمن في الخيارات التي ترسخ التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وفي مراجعة الوسائل وأشكال العمل والخطابات التي سادت طوال العقود الماضية. وبالتأكيد فإن ذلك يتطلب مراجعة المفهوم السائد عن «التحرير»، وتطوير معانيه، بحيث لا يقتصر على تحرير الأرض، وبحيث تشمل هذه العملية تحرير الفلسطينيين من علاقات الاستعمار والعنصرية والهيمنة الإسرائيلية، وتحرير اليهود ذاتهم من الصهيونية، وإضفاء قيم الحرية والمساواة والديموقراطية على عملية التحرير.
هذا يفترض، أولاً، فتح أفق الخيارات الفلسطينية وعدم إغلاقها إزاء التطورات المستقبلية المحتملة او الكامنة. وثانياً، عدم الانحصار في إطار خيار واحد ووحيد ولا في أي مرحلة أو ظرف. وثالثاً، مراعاة ربط كل الخيارات بالمشروع الوطني الديموقراطي، الذي ينبغي أن يجيب عن أسئلة كل الفلسطينيين، والذي يضمن وحدة شعب فلسطين، ويكفل حل المسألة الإسرائيلية.
ولا ننسى في هذا الإطار أن بناء المجتمع الفلسطيني، وتعزيز وحدته، وتنمية هويته الوطنية وكيانيته السياسية، ليست أمراً تفصيلياً، أو ثانوياً، في مواجهة المشروع الصهيوني، بل إن ذلك من صلب المشروع الوطني، وهو الأمر الغائب، منذ عقود، في إدراكات القوى المكونة للحقل السياسي الفلسطيني (المنظمة والسلطة والفصائل) مع الأسف.
وباختصار، فإذا كانت المفاوضات وإقامة كيان فلسطيني في جزء من الضفة (مع او من دون غزة) تتطلب التنازل عن قضية الفلسطينيين وحقوقهم، وعن كونهم شعباً، فما جدوى المفاوضات؟ وما معنى هذا الكيان؟
الحياة